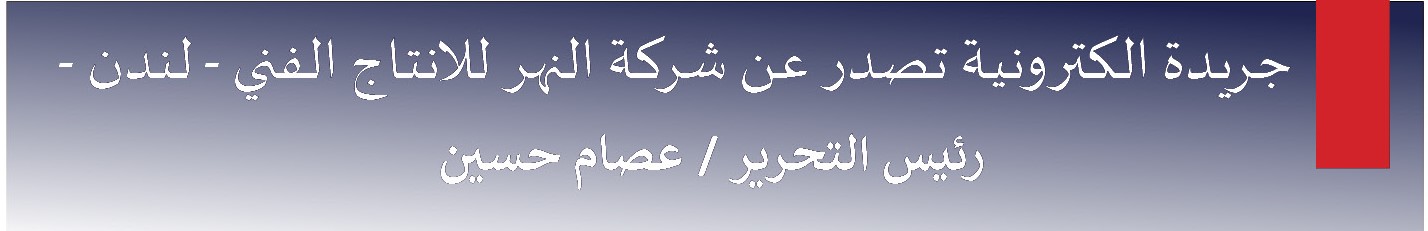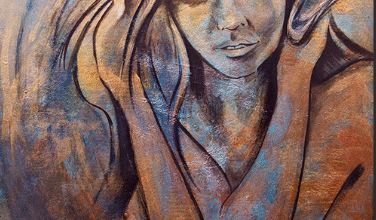” طعم الجبن الأبيض ” قصة قصيرة للقاصة المغربية سلوى ياسين


تدوين نيوز – خاص ، هل استطاع من بالداخل التعرف على الوجه والأذن الملتصقة بزجاج النافذة؟ الأذن التي حاولت جاهدة التقاط حديث دائر بين فمين خلال تلك العشية الصيفية؟ فم أحمر قان على النقطة المناسبة من وجه أبيض والفم الثاني بنفسجي على وجه أسود فاحم ولامع. زجاج الشرفة مطلي بصباغة بيضاء أسدلت خلفه ستارة رمادية. في الزاوية انقلعت قشرة الصباغة على مساحة تكفي لنظر عيني البنت المتلصصتين، قد يكون التقشير من صنع ريشة الطقس غير المبالية. أما الستارة فلم تكن لتغطي كل مساحة الشرفة… يُطلق على مثل هذه الصدف التي لا تفسير لها ألعاب الخفة يقوم بها القدر ليسلي نفسه كاشفا الأضحوكة التي هي الإنسان وهو يخطط بيقين وحماسة مضحكة لحياته. توقيت جيد وظروف مدبرة بدقة. سيكون للبنت جولات مع هذا القدر الذي سيتفنن في هندسة مشوهة لمواقيت حدوث الأمور في حياتها. ظروف تشبه أجواء الحرب. أما الحب فسيأتي متأخرا، كاشفاً لكوارث يخرجها مثل لسان بهلوان.
وعلى اختلاف الشفاه ورغم التنافر الصارخ بين الألوان، جمع بين الجسدين شيء واحد، كلاهما جسد أنثى، امرأتين على سرير واحد داخل غرفة بنافذة واسعة من الزجاج المصبوغ تطل على شرفة. حدث فريد سقط على جادة “مدام ميشيل” في حي لاسيندا من مكان مجهول واندس بين الأحداث البطيئة في قلب السأم الذي أنجبته سنوات الثمانينيات حتى صار الوقت فائضا يسمح لبنت بمراقبة “زهرة” و “ڤانة” تتضاجعان على سرير يتوسط غرفة مطلية بالأحمر كما لو أنها غرفة أعدت لزوجين/ لزوجتين/ لزوج و زوجته على السرير. ولعل ما حدث في عقلها من إرباك خلال ذلك اليوم الصيفي البعيد شبيه بما يحدث الآن داخل لغة الكلام من عراك وجودي. لتحلق حينها طفولتها ويجنح خيالها بعيدا. بنت لم تشاهد في حياتها زوجين من لحم ودم على سرير حقيقي. كل ما كانت ترغب به هو قطف حبات الجوز من الشجرة التي نمت حتى تدلت قطوفها على الشرفة الواسعة التي رصت بسيراميك أزرق وأبيض. لكن القدر لم يكن ليلتفت لمثل هذه التفاصيل التافهة، القدر يعشق العمل بعينين مغمضتين. في تلك اللحظة التي التقى فيها جسدا “ڤانة” و “زهرة” كما لو كانا نهرين هادرين من الشبق متجهين نحو المحيط، خيل للبنت أن فراشة بيضاء حامت بنزق بين أغصان شجرة الجوز ثم حطت على الزهرات الحمراوت كما لو أنها توحي بومضة عن شكل الحياة في السنوات القادمة، ولتمنحها فكرة عما لا يمكن تفاديه أو تجاوزه فلا أحد ينجو من الحياة. يطلق عليها “خديديج” تلك الزهور على أصيص الشرفة.
يتدلى أسفل أذن “ڤانة” قرط الذهب الذي لم يرها أحد قط من دونه، تزينه زمردة بلون أخضر داكن. كلما تحركت على السرير يتحرك القرطان باضطراب ويتشابكان مع خصلات شعرها المجعد. لم يكن الذهب وحده ما يلتمع على الوسادة البيضاء بل ومض أيضاً وجهها المحموم الذي يلتصق بوجه “زهرة” الأبيض مثل قطعة الجبن وأنفاسها المتلاحقة جعلت صدرها يعلو وينتفخ، ثم ينخفض وينكمش مثل مضخة تحت قبلات محمومة ومتواترة. الجبن الأبيض لقب أطلقته المعلْمة “ڤانة” على “زهرة” حين رأتها أول مرة.
ثمة خد ملتصق بالزجاج. يتزاحم بمحاذاة وجه البنت، خد عبد الرحيم الذي يطلق عليه الجميع لقب “بختة”، كونه مرتبط دوماً بقبيلة البنات، يلعب بصحبتهن ولا يحب مرافقة الأولاد، وقد كان وجوده بمثابة رمانة “التستسرون” التي تكبح حماسهن الأنثوي ورغبتهن المحمومة في جعل اللعب والفوز مسألة شخصية جدا. عبد الرحيم صديق البنات اللواتي لا ينسين أبدا الهزيمة وينتقمن دائما وسريعا. ظل الصغيران يراقبان ما يحدث بالداخل في صمت. ضيقت البنت عينيها لترى أكثر، باحثة عن سبب مقنع لالتصاق جسدي امرأتين يمكنه أن يجتث الذهول الذي أصابها.
لم يكن ذلك الولد غريبا عن البيت. بإمكانه أن يفتح باب الشرفة ويلج بيتا يعرفه ويقضي بداخله أغلب الأوقات. والدته “زهرة” خادمة أو ربما وصيفة، وأحيانا واحدة من نسوة فرقة المْعْلْمة “ڤانة “مغنية البلدة الشهيرة السوداء سواد السودانيين، سواد الكهرمان الصافي واللامع. هل كان ممكنا تحديد درجة ذلك الأسود بدقة؟ لون امرأة من السودان. من جنوب السودان على وجه الدقة. لو لم تلتق الآن بوصف “توني موريسون” في روايتها : “ليكن الله في عون الطفلة” تثق في “موريسون” كاتبة تزن الكلمات كما لو كانت أحجارا نادرة. وهي على يقين أن “ڤانة” تمتلك أسلافا سودانيين، كثيرا ما صدحت بأغنية “سودانة” خلال الليالي التي تحييها حتى تصير صباحات. تغني”ڤانة” أفضل من كل منافساتها. تغني كل الألوان وتمسك بالميكروفون بعذوبة وثقة شبيهة في ذلك بأم تمسك برضيعها. تضعه، الميكروفون وليس الرضيع، في الفراغ المناسب بين شفتيها البنفسجتين وتغني حتى يخيل للجميع أن بداخل “المعلمة” امرأة أخرى تبزغ فجأة مثل فجر لتصدح بأعذب التغاريد والمايات. تختفي تلك المرأة حين يتوقف الغناء، ليس هذا صوتها حين تتحدث في أيامها العادية إلى الناس العاديين. تنهمر الكلمات من فمها كما لو كانت جدولا أو سيلا هادرا نازلا من مرتفعات “أيت بوكماز” نحو السفح، تقود النسوة نحو بحيرة البهجة التي قلما يزرنها. وتتقد الجمل وتتوهج داخل صوتها كما لو كانت حمما صاعدة من فم بركان هائج :
وعلى لي طرا لي أنا ما نعاود
على العَود لي كان يجري و ما يشوف اللّور
وعلى الكسيبة لي بلا عدد ترعى و وراها ما تدور
و على خليلي لي مشا يجري، عريض و مخاوي كيف الثور.
مشا وما قال نشوف ديِك المرا لي خليت اللور.
يمتلك صوتها أسلوبا. قليل من الناس الذين عَرَفَتهم البنت يمتلكون أسلوبا فيما يفعلونه. الأسلوب هو الإنسان. وهذا تشبيه يُسمح له أن يصاغ في الاتجاهين. الإنسان هو الأسلوب أيضا.
وبعد الأسلوب، ما يجعل من المْعلْمة أيقونة هو الجمال الأخاذ الذي تمتلكه. حسن بلون مختلف. بشرة سوداء فاحمة. بهاء لا يمر دون أن يخطف النظر إليه. رغم أن الجميع حينها كانوا وربما ما زالوا يعتقدون أن الحروف الجميلة والخطوط البديعة لا تظهرها سوى الصفحات البيضاء… كأن الأبيض لون مقدس. كانت البنت ترى أن لون المعلْمة استثنائي وبهي. لكنها مع ذلك مجرد ظل معتم من دون صوتها الساحر بسب ذلك اللون. تمتلك ڤانه أيضا، أجمل عينين مفتوحتين بالكامل أبيضهما ناصع والبؤبؤ شفاف بني يسمح بمرور الضوء عبره. و لم تكن أي واحدة من النسوة تمتلك أسنانا مثل أسنانها. ببياض قد يؤذي عيون الناظرين إليها، كل هذا البهاء على جلد يلمع و له ملمس ناعم كما لو أنه ثوب من المخمل.
لم تتزوج “ڤانة” قط، أيام الثمانينيات في هذه البلدة الصغيرة في قلب ذلك الحي القرميدي كانت القوانين صارمة ومقاييس الجمال الأنثوي لا يحيد عنها أحد. الضجر ينجب هذا النوع من التفكير، الضجر سلاح ناعم وفتاك. كثيرا ما شعرت “ڤانة” أنها غير مرئية. ذلك السواد الحالك المسكوب على جلدها جعل قسمات جمالها البديع لا ترى. يقترب العشاق لتقبيل يديها، وهم مستعدون للركوع تحت قدميها حين تغني. حالما تتوقف عن الغناء يبتعدون. لا أحد يتجرأ على الارتباط بامرأة سوداء في تلك الأيام ولو كانت ملكة جمال الكون. الحب صنوُ الشجاعة.
حكت المعلمة للنسوة عن “علال” أغنى رجال المدينة. كان حلما ذلك الرجل. تذكرت انضباطه في الحضور إلى فندق “ترانس أطلانتيك” ليستمع إليها مانحا إياها الحماية وعيونا مُحِبة وعاشقة. يحدق ويمعن تحديقا فيها لساعات ولا يتعب. ممنوع على أحد الاقتراب. “ڤانة بامو” السوداء محمية خاصة. ينتظرها حتى تنتهي يقبلها ويمرر يده على وجهها ويقسم بجمالها، كما يقسم المؤمنون بآلهتهم. شعرت بصحبته أنها إلهة مرئية تستحق نظرات المؤمنين بها. أحبت ” ڤانة” “علال” وترقبت أن يقفز إلى سريرها هو الذي محض لها الحب بسخاء. لكن الأيام استبدلت زهرة بعلال على السرير. بعد خيبة الحب العظيمة يُغلق قلب المرأة إلى الأبد حتى يصير مجرد قبضة يد مضمومة بين الرئتين.
– أين هو الآن؟
كان هذا السؤال ملخص كل قصة حب غير مكتملة في الثمانينيات. غطاء من الكلمات على بركان الحب الهامد في القلوب وبداية أغنية ستؤلفها المعلمة على مهل. هل درى أحد أن المعلمة كانت شاعرة تظهر وتختفي؟
حام ظل الإشاعات طويلا حول فانة التي لم تر يوما برفقة خليل، تمنى الكثيرون لو يحصلوا على أخبار عنها غير أنها تغني في فندق “المحيط”، أو في أماكن أغلب المتلصصين عليها لم يكونوا يعرفون بوجودها أصلا. حتى ظهر التقرير الشهير للسعدية في أن المعلمة لا يمكن أن تعاشر الرجال ولن تتزوج أبدا. تقول إنها تلصصت عليها في الحمام وتخفت خلف البخار في الغرفة الساخنة ورأت ما لا يصدق. فمكان المهبل رأت قضيبا متدليا، وذلك يعني أن ڤانة السوداء كائن منزوع الجنس. أنثى مفرغة من الأنثى. ما الذي يعنيه ذلك؟ قالت البنت لنفسها، كيف يسمح الناس لأنفسهم بإلقاء المفردات على عواهنها دون تفسير. دون أن يأخد أحدهم يد ها ويشرح الأمر بوضوح. لم يكن ذلك تقليدا في تلك الأيام. قليلون من يعرفون أن تلك الأيام فترة صامتة تعاد فيها الأيام وشبيهاتها كل يوم دون توقف. هل كانت قبيلة مدام ميشيل تعرف ما يحدث داخل تلك الغرفة التي تطل على شرفة بالفسيفساء الأزرق والأبيض؟
لكن النسوة انتظرن اليوم الذي ذهبت فيه ڤانة مرة أخرى إلى الحمام و تبعنها وتأكدن من أن تلك أكذوبة .
_ انظروا إلى نهديها النافرين و مؤخرتها المدورة، تتوسط جسمها كما لو أن موضعها محسوب بالمليمتر.، تقول إحداهن. ذلك كاف لنعرف أن ما تقوله السعدية أكذوبة.
بعد اختفاء علال وجدت ڤانة الحب أخيرا في اعتناء زهرة بجسدها الذي انتُشِل من العتمة. تُرى زهرة على الدوام منشغلة بإعداد أعشاب العناية بالجسم. بتنقية الحناء وطحنها داخل الهاون الخشبي. تتحرك زهرة في الحمام المغربي بخفة لتحيط ذلك الجسد الخفي بالعناية الخاصة. تفركه تقشره وتنشفه. كل شيء يمر بسلاسة لا يقطعها عارض.
تذكرت البنت نظرات زهرة إلى جسد “ڤانة” الفاحم اللامع على السرير كانت نظرة خبير التحف المحترف. وهبته القيمة التي يستحق مثل أيقونة صنعت داخل قالب أو كما لو أنه تمثال فريد من القهوة ! بتلك النظرة وعبر الاهتمام اليومي بجسد “ڤانة” في البيت وفي الحمام البلدي حدث ربما الكشف الطارئ لنوع نادر من اللذة. وعلى السرير، استولت زهرة على السلطة التي كانت ترزأ تحت رحمتها. انقلاب أبيض مؤقت وسريع قبل أن تعود الأمور إلى نظامها في اليوم الموالي أو في الساعة التي تلي لقاء الغرفة الحمراء. مثل عودة قطعة فنية إلى موضعها المعتاد داخل متحف، أو بين جدران بيت “ڤانة” البديع، فبيتها يشبهها، أجمل بيت في الحي، لا تتلف فيه الأشياء، لا أطفال فيه ولا ضوضاء. كتب على باب ذلك البيت فيلاّ “بامو”.
“ڤانة” بين جدران فيلا “بامو” وخلف الشرفة الزجاجية في ذلك اليوم الصيفي العذب لم تكن لديها شروط أو طقوس ولا حتى أسلوب، بل بدت مذعنة بالكامل لليدين الخبيرتين اللتين عصرتا نهديها الضخمين الكبيرين الضاجين بالشهوة، يدا زهرة الخادمة التي لم يرها أحد إلا وهي تُؤتَمر وتطيع و كلمة ” لالّة” ونعم يا لالّة لا تغادر فمها. وعلى السرير بدت المعلمة مذعنة باستسلام شبِق لتعليمات لم تكن مسموعة، كانت تتحرك على السرير وفق خطة خفية. خطة الخادمة التي ترفع لافتة كتب عليها:” والآن، من السيدة يا ڤانة؟ إن جسدي الذي بلون وطعم الجبن الأبيض هو من يشرع ويسن القوانين.
ها قد رأت البنت أن للجسد المشتهى سلطة لانهائية، سلطة قادرة على تغيير الواقع. كيف صارت زهرة سيدة، و”ڤانة” تُؤتمر وتطيع. شهدت البنت مراسيم ذلك التبادل المؤقت للسلطة. حين تتبعت حركة الجسدين تحت الغطاء لمدة طويلة. وعلى الأرض طوح بقفطان ودفينة “ڤانة” المذهبين وحتى سروالها القندريسي الذي تخلعه حين ترغب في الصلاة غير بعيد منه قميص زهرة الطويل ومريلة المطبخ المطرزة.
شعرت البنت بخد عبد الرحيم وقد ترك مكانه على زجاج النافذة شاغرا. انصرف في صمت. عاد إلى شجرة الجوز ومنها نزل وركض نحو الحديقة، أما هي فراقبت بتركيز ما يحدث على السرير. قالت في همس:
– يجب أن نذهب الآن.
لكنها لم تتحرك من مكانها. لماذا لم تركض حينها بعيدا؟
صارت الغرفة تعتم قليلا مع الغروب، رؤية الجسدين يتحركان وينزلقان ببطء على السرير ما زالت ممكنة، لم تتوقف القبل المحمومة. صار وجه “زهرة” يشع في آخر الغرفة مثل مصباح داخل جيب، طوحت “ڤانة” بالغطاء بعيدا وانكشف عالم ما تحته. يشبه عالم ما بعد الموت الذي ليس لأحد الحق في التلصص عليه، ممنوع الكشف عنه. لو تكشف لنا بالصدفة علينا أن نغمض أعيننا ونركض بعيدا مذعورين. لكن البنت لم تركض بل انجذبت أكثر فأكثر، قوة الفضول تشبه المغناطيس. تغير العالم من حولها في ذلك اليوم وشعرت أنها عبرت الخط الفاصل نحو مجرة جديدة خاوية. مجرة الشهوة. فردت “ڤانة” ذراعيها وساقيها في ما يشبه استعدادا للعناق. لكنها لم تعانق.
ظلت البنت تراقب وتتمنى أن تنسى كل شيء في الغد. من الأفضل أن تمحو كل ما رأته. وهي ترجو أن يذوب كل ما رأته مع شمس الصيف. ثمة ذكريات لا تصلح لشيء. تفسد بسرعة مثل جبن طري. حين نزعت زهرة الغطاء وتكشّف للبنت أن كل واحدة منهما تشغل مكانا مناسبا في منتصف السرير. جسد أسود لم يعد يلمع الآن تحت جسد أبيض يومض مثل يراعة في عتمة الغرفة. ساح الكحل في عيني زهرة. ذلك الكحل الذي قضت قبيل العصر تحت شجرة البرتقال تخطه وتمسح وتدمع وتعيد ذلك مرات، تبكي بدموع اصطناعية وتجرف ما يفيض عن العين بمنديل أبيض. تشمس رجليها المخضبتين بالحناء وبالقرب منها كانت ڤانة تدهن يديها وقدميها وتغني بصوتها الذي يترقرق من البحيرة الساكنة في قعر جوفها. خافت كان صوتها لكنه مسموع عذب ولذيذ.
آلاّلة في القبة تحني
طالبة بالشريف يولّي
وا جود علي يا مولاي.
لا مي لا بابا
لا من سال عليَّا
من بين أسنانها كان حرف الشين ينزل سينا، و من الصعب أن تنطقه صحيحا، ربما كانت قشرة الذهب التي تغلف ثلاث قواطع من أسنانها، هي السبب. مما جعل حروفا تحلق خارج فمها بموسيقى وبنبرة مختلفة. يبدو جليا أن ڤانة كانت تغني لزهرة مثلما قد يغني عاشق لحبيبته.
دلفت حمرة الغروب إلى الغرفة وساحت وغمرته بالكامل واهبة للجسدين هيأة أيكة وحيدة في صحراء استوائية، لقد انقضى اليوم بصور شائكة ومرعبة. لم تكن خائفة من أن تضبط وهي تلتقط حبات الجوز التي سقطت على الأرض. تلك الحبات ناضجة ولا تحتاج و قتا طويلا لتجف وتؤكل. غادرت البنت الشرفة تاركة العاشقتين بالداخل تتلاحق أنفاسهما وتتسارع كما لو كانتا مصارعتين على حلبة. لم تر في حياتها مصارعتين و لا امرأتين على سرير واحد. كانت رغم ذعرها ترغب في العودة إلى النافذة علها تنجح في التقاط حوار بين حجر كهرمان وقطعة الجبن الأبيض وهما تنفذان خطط السرير الذي تلهبه شهوة حارة. هل كان ذلك رقصا أم غناء؟ هل تشدو المعلمة حتى تحفظ زهرة وتردد خلفها :
و لي يشهد بالزور
راه مليوح على برا
والله ما ننساك و لا نقطع رجاك
هل هذا ما كانتا ترددانه فما لأذن.
التفت عبد الرحيم في إشارة إلى أن وقت اللعب قد حان. ركضا داخل الحديقة، تسربا من بين الأشجار، لوز وبرتقال وصفصف؛ أشجار تقف مثل نواطير تحرس الشرفة الزجاجية للعاشقتين. تمشيا على العشب فبدت لها سيقانه بعد كلما رأت مثل شفرات فضية حادة تلمع تحت شذرات شمس الغروب. ذلك ما تصنعه الصدمة،إعادة تشكيل العالم في عيون المصدومين. كأنها لا تعرف هذا البيت، كأنه شيد قبل ساعة فقط.
عبرت بستان المعلمة دون أن تقطف شيئا. لقد حدثت التخمة المزعجة في نفسها. مشت حتى الباب الكبير دون خوف، دون أن تتوقع في أي لحظة سماع اسمها يحلق خارجا من فم زهرة مستفسرا عن سبب الزيارة. عبرت الحديقة تحت عيني الكلب. اللبس الذي امتلكها كان عاصفا. هل ستغني ڤانة مرة أخرى بذلك الفم الذي كان ذائبا تحت وابل القبل الغريبة المقززة. لم يكن له اسم ذلك الكلب، لا يلاعبه ولا يداعبه أحد. كلب حراسة ونباح فقط.
هل يقبل الأزواج نساءهم بتلك الطريقة؟ هل ستحكي للبنات عما رأت؟ ربما تستأهل ما حدث لها خلال تلك العشية من جلجلة عظيمة ستحكم القادم من أيامها. رددت جملة قرأتها في كتاب ما، أو سمعتها على الراديو أو على التلفاز، لا تدري، الكلمات تحلق في كل مكان :”الفضول قتل القط”. قتل ملايين القطط.
توقف عبد الرحيم عند الباب الكبير، ثم عاد إلى البنت التي كانت تتمشى ببطء لتدرك الباب. جذبها واقتعدا العشب.
تناهى إلى سمع البنت وهي على العشب صوت موسيقى بعيدة، وغناء فانة الشجي. مع أن صوتها لم يكن ليحتاج موسيقى، صوتها من النوع الذي قد تشوش عليه الآلات مثل صوت ناظم الغزالي. لم يكن غناء ما يتدفق من حلقها، بل يشبه بكاء بدموع لا ترى. نفس الأغنية التي كانت ترددها داخل الحضرة حين كانت النسوة يرقصن بطريقة غريبة، تنحدر رؤسهن وأكتافهن إلى الأمام ثم إلى الخلف، كان ذلك شبيها بطقس استحضار للأرواح التائهة في أبعاد أخرى من الكون. استحضار الأرواح أو المعاني والأشياء التي لم تعد تنتمي إلى العالم.
– تغلق أمي باب غرفة النوم وتلعبان هي وفانة دائما. قال عبد الرحيم.
– تلعبان؟
نعم أمي تزوجت وهي لم تجاوز الثانية عشر، صغيرة جدا، ولم تلعب قط مثلنا، قبل زواجها كانت تقضي اليوم في تلك القرية البعيدة العالية في جلب الماء، وحلب البقرة و رعي الغنم. لو تفرجت على صور زفاف أمي لرأيت كيف كانت نحيفة وقصيرة. والآن هي أطول امرأة في الحي. تزوجت أمي و هي ما تزال طفلة في عمرك وأكملت نموها بعد الزواج، لو كان بإمكانك رؤيتها في تلك الصور لشاهدت رسغيها الرقيقين وذراعيها اللتين تشبهان قصبتي خيزران.
– لم تذهب إلى المدرسة؟
– لا توجد أي مدرسة داخل ذلك الدوار ولا في الدواوير المجاورة. أخبرتني أمي أنها لم تلعب أبدا حين كانت صغيرة، وعدتها جدتي أنها حين ستتزوج ستلعب كثيرا، ولما تزوجت رأيت أبي يقدفها بسطل من القصدير أدمى ساقها، وذلك لم يكن لعبا بالتأكيد، ولم يكن ليكتفي بذلك بل يسقطها أرضا يرفس جسمها وحتى وجهها. حكى عبد الرحيم ذلك دون أن تدمع عيناه، وحتى حين بدأت البنت في البكاء لم يحاول تهدئتها.
– واسيت أمي في كل مرة يبرحها أبي ضربا. بتقبيل يديها وبطاعتها غير المشروطة. أحيانا كنت أعدها بأنني سأقتله حين سأكبر. كانت تجيب أن بداخل أبي شخص خفي يظهر دون أسباب واضحة لا يهدأ إلا إذا صرخ وركل ورفس.
– يوما ما سيقتل والدك أحدا. وإذا لم يوجد ذلك الشخص سيقتل نفسه. ذلك ما كانت تردده لتشرح لي حالة الوحش التي تتلبس أبي من فترة لأخرى.حاربت أمي بكل الطرق حتى لا أصير مثله. لم تترك أي فرصة لتذكرني بأنها لن تترك وحشا ينمو بداخلي ولن أشبه أبي أبدا. وإذا كنت قد ورثت بذرة الجنون منه ستجتثها قبل أن تبرعم.
بعد أن هربنا حتى بيتكم وبعدها إلى بيت المعلمة قلت لنفسي أخيرا وجدت أمي الوقت لتلعب. تلصصت عليهما مرات عديدة. لم يزعجني ذلك. وحتى لو أخبرت البنات. ما عاد الأمر يهمني. بعد أن أفلتنا أنا وأمي من بين فكي الغول. كل شيء سيكون هينا. يروي عبد الرحيم كل ذلك تحت ما تبقى من شمس العشية كما لو كان يهذي بصوت خفيض مخلوط بأنين خافت.
قفزت بداخل البنت ذكرى ذلك الصباح البعيد. تذكرت اليوم الذي طرقت فيه زهرة باب بيتها، نزلت ببطء من غرفتها وتسللت لتشاهد الجدة والعمة والأم يجلسن في ركن البهو و زهرة على الأريكة المقابلة وعبد الرحيم يخبئ وجهه خلف ذراع أمه. كان وجهها معجونا باللكمات، بالقرب من قدم زهرة رأت قفة ضخمة من القش، وعلى المائدة وضعت أربع سلال صغيرة من الجبن الأبيض مغطى بأوراق الدوم الأخضر.
وقد أخذ الأمر من زهرة ساعات لتروي ما حدث. حكت عن خطة هربها المتقنة وبين كل جملة و أخرى تمسح الدم الذي ما يزال طريا من شفتها متفادية لمس العين المتورمة البنفسجية. حكت أن زوجها لم يكتفي بتسديد لكمات فقط فبعد أن سقطت على الأرض صارت الركلات توجه إلى صفحة وجهها وباقي أجزاء من جسدها. نزعت الجلباب ثم الدفينة وراحت تريهن العلامات الحمراء التي تغطي جسمها الأبيض. لم تجد حرجا التعري أمامنا كانت في تلك المنطقة من الألم التي يجعل المرء لا يكترث. لا تجد النسوة عموما أي عائق ليتعرين أمام عيون بعضهن. الحمام المغربي تدريب جيد على تلك الحميمية الخاصة بين أجساد النساء هنا.
كانت تبكي ولا تهتم بمسح الدموع والمخاط من أنفها، نظرت البنت إلى وجه أمها، جدتها ثم عمتها ووجدتهن يبكين. بكت. لم تر البنت في حياتها وجها عليه خطوط. تخيلت حذاء ذلك الزوج كما لو أنه طابعة وشمت على وجه زهرة نقوشا. أخذت إلى الحمام في ذلك اليوم فرغم الألم الماء الساخن يخفف من الكدمات. ظل ذلك الصباح وما بعده من أيام مخلوطا بصور الكدمات وسيلان الدم والمخاط في ذاكرة البنت، صار الجبن الطري الذي تشرب رائحة أوراق الدوم الأخضر هو العطر الرسمي لألم النساء.
قضت زهرة وعبد الرحيم أكثر من شهر في بيت البنت. تردد الجدة أن زهرة قريبة. ربما ليست ابنة خال وعم إلا أنهما من قبيلة وبلدة ودوار واحد ولن تتخلى عنها وعن ابنها مهما حدث. أُرسلت بعدها إلى بيت ڤانة التي كانت بحاجة إلى خادمة. وحين كشفت لها عن جسدها المظلوم. بكت المعلمة أيضا . انتحبت وغنت بعدها مواويل أمام الجميع، بكت البنت حينها. ينمو نوع نادر من التعاطف بين النساء في لحظات مثل هذه. تحلق الغيرة بعيدا ويحل مخلها تعاطف مذهل.
– وهل هذا الجمال يلكم و يضرب؟ قالت ڤانة .
ولا يمكن ألا ندرك أن الجمال قيمة ملحة وتعلو فوق كل شيء في تلك الأيام، حيث من خلال تلك الجملة يمكن للمرء أن يفهم أن لكم و رفس امرأة قبيحة أمر مسموح.
خلال وقت قصير صارت زهرة تتفتح وتتحسن حالتها وصار البنفسجي الذي بقع جسدها يخفت ويصير أزرق ثم أخضر وبعدها تبدد لتسترجع زهرة لونها الأبيض النادر. فهمت البنت أن لون اللكمات الذي بدأ أحمرا ينتهي إلى أصفر فاتح حتى يختفي تماما.
كانت المعلمة نجمة الحفلات التي تحيى داخل تلك البيوت. الحفلات كانت محدودة في الزمن بين الظهر المغرب وبعدها وبانضباط نادر تلهث النسوة نحو بيوتهن. أغلبهن كن يرزحن تحت سلطة الخوف. لكن تلك الساعات القليلة مشحونة بالكثير من أنواع السعادات. سعادات متفرقة إلى أجزاء صغيرة مدسوسة في التفاصيل اللانهائية. سعادة فخر المرأة الجميلة والبيضاء بنفسها، سعادة أن تعلق النساء أن ذلك لا يكفي يحتاج الاحتفاظ بالزوج أكثر، سعادة الفتاة الطويلة وتملك عينين ملونتين وشعرا يصل حتى مؤخرتها، وذلك لم يكن ليكفي من أجل الحصول على زوج، سعادات ارتداء القفاطين الجديدة غير المكررة والأساور التي تحدث جلجلة بين أصوات الزغاريد التي ترتفع في البهو دون مبرر، صيحات نشوة النساء الصامتات على الدوام المخبئات خلف الأسوار سعادات البخور و العطور والحلويات والأكل الدسم. تصل المعلمة وفرقتها. تعزف بإتقان نادر على طبلين ملتصقين ببعضهما واحد أكبر من الآخر . لا تسمح بأن تفسد العازفات الإيقاع الذي يجب أن يتبع الطبلة، أن يقلدها أو أن يتممها ومن نظراتها قد نفهم إن كانت راضية عن الفرقة أو غاضبة. يحكى أنها خلال إحدى حصص التدريب على أغنية جديدة وحين تعبت من النظر شزرا إلى إحدى العازفات في فرقتها انتهت بقدفها بإبريق الشاي الفضي أصاب منتصف جبهتها.
حين تبدأ الفرقة في عزف موسيقى الحضرة فذلك إعلان بنهاية الحفلة. يُتوقع حينها سقوط النسوة المصابات بداء الحال على الأرض. ظنت البنت أن ذلك السقوط المتوالي لامرأة بعد أخرى موت مؤقت. أو مرض نادر لا يعرف عنه الطب شيئا ومن الصعب فهمه أو إيجاد تفسير له في الكتب. كان ذلك الوقوع على الأرض ممزوجا بصرخة المرأة شبيها بغيبوبة مفتعلة مؤقتة، لا يفزع أحدًا، لا شيء مقلق. انهيارات موجزة في الزمن يُنسى فيها ثقل الوجود للحظات، بعد انتهاء الحفلة يسود صمت رهيب. الصمت المدوي الذي يلي الضرب القوي على الطبل.
صمت صاخب ذلك الذي خيم على سنوات الثمانينات في حي لاسييندا. هل كانت ڤانة تغطي بذلك الغناء العذب على ما يدور في الغرفة الحمراء وعلى علاقتها بزهرة؟ هل صنعت بذلك الضرب على الطبل الضخم صخبا تتستر تحته غابة الأسرار. صار واضحا للبنت الآن أن العلاقة التي نمت بين زهرة وڤانة هي تلك التي تربط العبد بالسيد. لا يستطيع العبد الاعتراف بنفسه الا بعدما يعترف السيد بوجوده. كلا المرأتين كانتا بحاجة لتلك اللحظات التي ينظران فيها لبعضهما. ليتأكد وجودهما. حينها صار جسد زهرة مضيئا وخاليا من التعذيب والتمثيل الذي تعرض له بعد زواج فاقد للمنطق. زواج الوحش بالطفلة. ولطالما لم يجد جسد المغنية الأثيرة عينا تنظر لجمالها الأخاذ وتعترف به على الملأ، جمال كان يستحق شجاعة عاشق مثل علال، جمال لم يترك له سواد البشرة الفاحم الفرصة ليُعترف ببداهته.
ظلت تلك الأيام في مخيلة البنت حقبة صامتة لم تقدم لها أي توضيحات عما سيكون عليه المستقبل الذي تعيشه الآن وهي تغوص في سنواتها الثلاثين أدركت أن الحياة ليست هي ما يطفو على السطح. الحياة الحقيقية تستوطن الظل والعتمة. هي أيضا مثل ڤانة لا تستطيع فك طوق فستانها، في هذا العمر مازال جسدها غير مرئي يرزأ تحت الانتظار … انتظار العين المكتشفة، المحدقة. تذكرت معنى أن يكون جسد امرأة خافت الظهور وغير مرئي. جسد مقموع قد يشتهي أحيانا بعض اللعب الذي لا ينصاع للقوانين.
بدأ الغروب يزحف نحو البيوت القرميدية، وخفت إيقاع الحي، كان ذلك مطمئنا. وقف عبد الرحيم ثم ركض حتى رأس جادة مدام ميشيل وصاح:
– هل نتسابق؟
– هيا . أجابت البنت.
A vos marques ! –
وضع كل منهما ساقا إلى الأمام و أخرى إلى الخلف.
Prêt!-
رفعا عجيزتيهما إلى أعلى، انتبهت البنت إلى أن عبد الرحيم لا مؤخرة له تقريبا.
– أنا سأجري باسم سعيد عويطة وأنت ستكونين نزهة بدوان.
بل أريد أن أكون سعيد إنه يربح دائما وأنتَ ستكون نزهة هذه المرة. ردت البنت.
أنا رجل، أنت بنت.
سأكون أنا الرجل هذه المرة، دعنا نلعب ذلك،
نظر عبد الرحيم طويلا في اتجاه الطريق. لم يرد.
Partez !-
ركضا بكل اندفاع.
أغمضت البنت عينيها علها تتذكر سعيد عويطة وهو يركض خلال ألعاب لوس أنجلس عام 1984 ولأنها تظن أن النظر يشتت تركيزها، ركض عبد الرحيم جاحض العينين. فتحت عينيها بعد الانطلاق بثواني قليلة التفتت وجدت أن عبد الرحيم يحدق فيها . مثلما يحدث في الأفلام، ينظر البطلان داخل أعين بعضهما البعض. حديث دون كلمات.
– ماذا قلت؟
_ لم علي أن أكون دائما أنثى، وكيف عرفت أنني الأنثى وأنك الذكر؟ ما الذي يجعلك متأكدا من ذلك ؟
– أنا أعرف لأنني أكبر منك. أنا على يقين.
ركضا حتى آخر الشارع تاركين قوة المنحدر تدفعهما.
اليقين، ستظل تلك الكلمة ترن بداخلها طيلة السنوات التي تلت تلك العشية الصيفية حينما اكتشفت داخل تلك الغرفة الحمراء شكلا آخر للعب الذي قد يشتهيه الكبار. مرت أيام عديدة ولا أحد فهم ما الذي حدث لتلك البنت التي كانت تحدق طويلا في السياج الفاصل بين بيت “ڤانة” و بيتها. تأخذ كرسيا وتقتعده تحت شجرة البرقوق تنظر وتتمنى لو تفقد ذاكرتها. أن تُمنحَ ماكينة حلاقة لمسح كِدَس الصور التي التصقت ببصرها. لم تكن ترى سوى يدا زهرة تعصران ثديا المغنية في تماثل وتوقيت متوازيين. ماذا كان ذلك؟ ما الذي كان يحدث داخل الغرفة الحمراء؟
هل كان ذلك حقا محض لعب؟ ما حدث على السرير بين جسدين متماثلين ومتشابهين جدا واحد أسود وآخر أبيض. هل كان ذلك لعب الكبار الذين يخشون ضياع هيبتهم. أم مجرد اكتشاف بالصدفة لشكل وطعم آخر للحب أو للعب بالحب مثلما اكتشفت فتاة في الثانية عشر من العمر خلال ذلك الصباح البعيد طعما آخر للجبن الأبيض الطري وقد امتص رائحة ونكهة الدوم الأخضر.