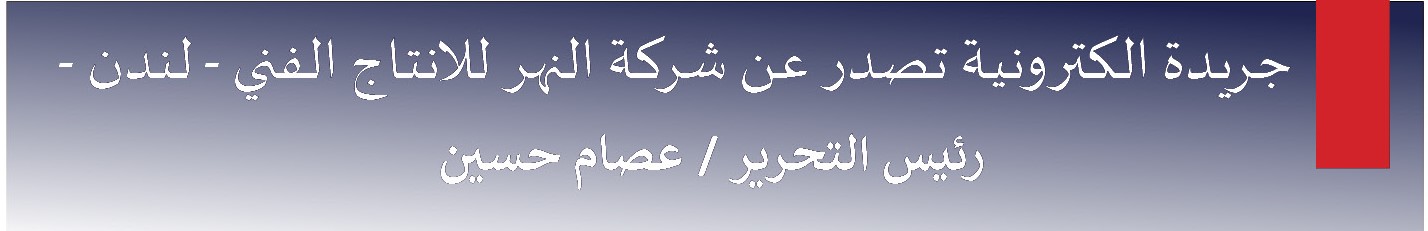سبعة عشر إنجليزياً مسموماً / قصة غابريل غارسيا ماركيز
ترجمة علي سالم عن الإنكليزية من مجموعة Strange Pilgrims الصادرة عن دار Jonathan Cape London 1993

تدوين نيوز – خاص

الشيء الأول الذي لاحظته السنيورة برودنثيا لينيرو عندما وصلت ميناء نابولي هو رائحته التي ذكرتها برائحة ميناء ريو هاشا. وبالطبع لم تخبر أحداً بذلك، لأن لا أحد من ركاب تلك الباخرة الخطية العجوز من طليان بوينس آيرس العائدين لرؤية وطنهم الأم، لأول مرة منذ الحرب، والذين تكاد الباخرة تفيض بهم، كان سيفهم مغزى ملاحظتها هذه، لكنها على أي حال، رغم عمرها البالغ اثنان وسبعون عاماً، ورغم السفرة الطويلة التي استمرت لثمانية عشر يوماً متواصلة في بحار عاتية بعيداً عن أهلها وبيتها، شعرت بأنها كانت أقل وحدة، وأقل خوفاً ونأياً.
كانت أضواء اليابسة قد برزت للعيان منذ الفجر. وكان المسافرون قد غادروا أسرّتهم في وقت أبكر من الوقت المعتاد، بثياب جديدة، وقلوب مثقلة بشكوك النزول على الشاطئ، بحيث بدا لهم الأحد الفائت الذي أمضوه على متن السفينة وكأنه اليوم الوحيد الحقيقي في الرحلة كلها. كانت السنيورة برودنثيا لينيرو من المسافرين القلائل الذين حضروا القداس. وخلافاً للثياب الشبيهة بثياب الحداد التي ارتدتها من قبل، لتقوم بجولة حول السفينة، ارتدت اليوم ثوباً من التُنك الأسمر الغليظ مزنراً بحبل القديس فرانسيس، ونعلين جلديين خشنين لا يشبهان نعلي حاج، فقط لأنهما كانا جديدين تماماً. كانت تلك الثياب تمثل بادرة شكر مبكرة للرب تعبيراً عن العهد الذي قطعته على نفسها أمامه بارتداء مسوح الراهبات بقية حياتها لو حقق لها أمنيتها بالسفر الى روما لرؤية الحبر الأعظم، والآن تعتبر أن الرب قد أستجاب لها وبارك لها تلك الأمنية بالفعل. عند نهاية القداس أوقدت شمعة الى الروح القدس عرفاناً بالجميل على إلهامها الشجاعة التي مكنتها من تحمل أنواء البحر الكاريبي، وصلّت لكل طفل من أطفالها التسعة وأحفادها الأربعة عشر الذين كانوا يحلمون بها في تلك اللحظة بالذات، في ليلة من ليالي ريوهاشا العاصفة.
عندما صعدت الى سطح المركب بعد الفطور، كانت الحياة قد تغيرت على ظهر السفينة. كان العفش مكوماً في صالة الرقص، الى جانب جميع أنواع الحقائب السياحية التي ابتاعها الطليان في أسواق الأنتيل السحرية، وفوق بار البهو جلس قرد من فصيلة المكاك جُلب من برنام بوكو داخل قفصه الحديدي. كان صباحاً رائعاً من صباحات أوائل أغسطس / آب. واحداً من صباحات تلك الآحاد الصيفية المثالية لفترة ما بعد الحرب التي كان فيها الضوء يشبه إلهاماً يومياً. تقدمت السفينة الهائلة بتؤدة، وبأنفاس متقطعة كأنفاس رجل مريض، خلال الماء الساكن الشفاف. ولاح في الأفق الحصن الكئيب لأدواق أنجو، وظن الركاب الذين تجمعوا على السطح أنهم تعرفوا من جديد على أماكنهم المألوفة، فأخذو يشيرون اليها حتى قبل أن يكونوا قد رأوها تماماً، وهم يصيحون فرحين بلهجاتهم الجنوبية. أما السنيورة برودينثيا لينيرو، التي كسبت الكثير من الأصدقاء العجائز الأعزاء على المركب، وكانت تتبرع برعاية الأطفال الذين يذهب آبائهم للرقص، حتى انهم خاطت أحد أزرار بدلة الضابط الأول، فقد وجدت، لدهشتها، أن جميع أصدقائها قد أصبحوا غرباء وبعيدين. وأحست بإن الروح الاجتماعية والدفء الإنساني اللذان سمحا لها بتجاوز مشاعر حنينها الأولى تحت حرارة المدار الخانقة قد اختفيا الآن. وهاهي تشهد بمجرد أن ظهر الميناء للعيان كيف تنتهي قصص الحب والصداقات الأبدية التي تُنسج في أعالي البحار. ظنت السنيورة برودنثيا لينيرو، التي لم تكن معتادة على طبيعة الطليان المهذارة، إن المشكلة لا تكمن في نفوس الآخرين، بل في نفسها هي بالذات، لأنها كانت الوحيدة التي تسافر بلا رفيق مع هذا الحشد العائد الى أرض الوطن. وفكرت وهي تشعر للمرة الأولى بذلك الألم المبرح الذي يصاحب إدراك المرء لغربته المفاجئة بأن أي رحلة أخرى لابد أن تكون مثل هذه. اتكأت على الحاجز وأخذت تفكر بمخلفات الكثير من العوالم المنقرضة المترسبة في أعماق المياه. فجأة أفزعتها بصرخة مرعبة فتاة جميلة جداً تقف الى جانبها:
Mamma mia” “صرخت الفتاة مشيرة الى الأسفل، “أنظري هناك!”
لقد كان رجلاً غريقاً. رأته السنيورة برودنثيا لينيرو يطفو على ظهره، رجل ناضج، أصلع، ذو مهابة طبيعية نادرة، عيناه المفتوحتان السعيدتان لهما لون السماء في الفجر. كان يرتدي بدلة سهرة كاملة مع صديري مقصب، وحذاء جلد مفصل خصيصاً له، وفي طية سترته كان ثمة زهرة يانعة. في يده اليمنى كان يمسك علبة صغيرة مربعة ملفوفة بورق هدايا، وأصابعه الحديدية الشاحبة متمسكة بمقدم السفينة، وهو الشيء الوحيد الذي أتيح له التمسك به لحظة موته.
لابد انه سقط من حفلة عرس قال أحد ضباط السفينة يحدث هذا الشيء كثيراً في هذه المياه أيام الصيف.
لقد كان مشهداً عابراً، لأنهم في تلك اللحظة بالذات كانوا يدخلون المرفأ، حيث شرعت أمور أخرى أقل مأساوية تستحوذ على اهتمام الركاب. لكن السنيورة برودنثيا لينيرو ظلت تفكر بالرجل الغريق، الرجل الغريق المسكين، الذي كان ذيل سترته الطويلة يتموج في فورة الماء الخارجة من تحت السفينة.
تقدم قارب سحب عتيق، حالما دخلت السفينة الى المرفأ، وأقتادها من أنفها عبر متاهة من حطام مراكب عسكرية دُمرتها الحرب. وعندما شقت السفينة طريقها عبر غابة الهياكل الصدئة، أخذ الماء يستحيل زيتاً، وأصبحت الحرارة أشد حتى من حرارة ريوهاشا في الثانية بعد الظهر. وبرزت المدينة على الجانب الآخر من القنال الضيق، متألقة تحت شمس الضحى بقصورها الخيالية وبيوتها العتيقة الملونة المكدسة فوق التلال. في هذه اللحظة انبعثت من القعر المضطرب رائحة عفن شديدة، ذكّرت السنيورة برودنثيا لينيرو برائحة السراطين النتنة المنبعثة من فناء دارها.
وبينما كانت هذه المناورة تجري، ميّز الركاب الذين كادوا يطيرون من الفرح أقاربهم وسط الحشد الذي تجمع على رصيف الميناء. ومعظم هؤلاء الأقارب كن سيدات في خريف العمر ذوات صدور ضخمة، يرتدين ثياب حداد سوداء تكاد تخنقهن ويملكن أكثر الأطفال جمالاً وعدداً في العالم. الى جانبهن كان يقف أزواج صغار الأجسام، يقظون، من النوع الخالد الذي يقرأ الصحف بعد فراغ الزوجات منها، والذي يتلفع دوماً بثياب رسمية صارمة كثياب كتاب العدل، رغم أنف الحرارة.
في وسط هذا الهرج الكرنفالي قام رجل عجوز يرتدي معطفاً قذراً وله وجه يتجاوز بؤسه حدود المواساة بإخراج حفنة كبيرة من كتاكيت الدجاج الصغيرة من جيبية بكلتا يديه. وفي لحظة غطت الكتاكيت كامل الرصيف، مهتاجة وموصوصة، وبسبب كونها كتاكيت سحرية فقد نجا العديد منها وواصل جريه حتى بعد وطئها بأقدام الحشد الذي لم يكن منتبهاً لهذه المعجزة. قلب الساحر قبعته ووضعها على الأرض، لكن لا أحد من الواقفين عند الحاجز قذفه بقطعة نقد واحدة، ولو على سبيل الإحسان.
افتتنت السنيورة برودنثيا لينيرو بغرابة هذا العرض العجيب الذي بدا وكأنه كان يقدم على شرفها، لأنها كانت الوحيدة التي قدرته حق قدره، ونتيجة لانشغالها بالعرض لم تنتبه للحظة التي أنزلوا فيها معبر النزول الذي أحتله على الفور سيل بشري انهال على السفينة بزخم مدو كزخم هجوم قرصاني. أصابها صوت الابتهاج الجامح هذا ورائحة البصل الزنخة المنبعثة تحت وطأة القيظ من أفواه العديد من العوائل، بالدوار، ووجدت نفسها تُدفع هنا وهناك من قبل زمر من الحمالين المتنافسين على نقل العفش لحد تبادل اللطمات. وشعرت بأن الموت الشائن الذي كان يتهدد الكتاكيت الصغار على الرصيف كان يستهدفها هي أيضاَ، فجلست على صندوق ثيابها الخشبي ذو الزوايا المعدنية المطلية غير آبهة بشيء، وشرعت ترتل سلسلة من الصلوات الحميمة لحمايتها من الغواية والأخطار في هذه الأرض التي فقدت إيمانها. وعندما انحسر المد البشري وجدها الضابط الأول تجلس وحيدة في صالة الرقص المهجورة.
“لا يُسمح لأحد بالبقاء هنا الآن،” قال لها الضابط بود حقيقي.
“هل تسمحي لي في المساعدة بشيء؟”
“يجب علي انتظار القنصل”
كان ذلك صحيحاً. فقبل يومين من إبحارها، أرسل ابنها البكر برقية لصديقه قنصل نابولي، راجياً منه ملاقاة والدته في الميناء ومساعدتها في إتمام إجراءات الدخول لكي تواصل مسيرها الى روما، ذاكراً له أسم السفينة ووقت وصولها، وإمكانية التعرف على أمه لأنها ستكون مرتدية مسوح القديس فرانسيس عند وصول سفينتها الى المرسى. لقد كانت متمسكة جداً بهذه الترتيبات بحيث لم يجد القبطان بداً من تركها تنتظر لفترة أطول، رغم اقتراب موعد غداء أفراد الطاقم، الذين شرعوا فعلاً بوضع الكراسي على الطاولات وبدأوا بغسل الأرضية بجرادل الماء، مضطرين لتحريك صندوق ثيابها عدة مرات لمواصلة العمل، لكنها كانت تغير مكانها كلما طلبوا منها ذلك دون أن يطرأ أي تغيير على تعابير وجهها، ودون أن تقطع صلواتها، حتى أخرجوها أخيراَ من صالة الاستجمام وتركوها تجلس في وهج الشمس وسط قوارب الإنقاذ. وهناك وجدها الضابط الأول للمرة الثانية غارقة في عرقها داخل مسوح التوبة مرددة صلواتها دون أمل لأنها كانت تشعر بالخوف والحزن، سلاحيها الوحيدين الذين كانت تدرأ بهما الانخراط في البكاء.
قال الضابط وقد تبخرت من وجهة ملامح الود كلياُ: “من الغير المجدي بالنسبة لك الاستمرار في الصلاة، فحتى الرب نفسه يذهب في أجازة أيام أغسطس”
ثم أردف قائلاً بأن نصف إيطاليا في هذا الوقت من العام تذهب الى الساحل، خصوصاً أيام الأحد. وإن القنصل لم يذهب على الأرجح في أجازه، نظراً لطبيعة عمله، لكن من المؤكد إنه لن يفتح مكتبه حتى يوم الاثنين. إذن الشيء الوحيد المعقول هو النزول في فندق، والنوم جيداً لليلة واحدة، ثم الاتصال به تلفونياً في اليوم التالي؛ ولا شك أن نمرته موجودة في دفتر التلفونات. لم تكن السنيورة برودنثيا لينيرو تملك أي خيار غير القبول بقرار الضابط الأول الذي ساعدها في إجراءات الهجرة والجمارك وتبديل النقود ووضعها في سيارة أجرة، مقدماً للسائق تعليمات غامضة حول ضرورة أخذها الى فندق محترم.
شرعت سيارة الأجرة التي لاتزال تحمل آثار حياتها السابقة كعربة لنقل الموتى في السير مترنحة داخل الشوارع المهجورة. وظنت السنيورة برودنثيا لينورا للحظة أنها والسائق كانا آخر من بقي على قيد الحياة في هذه المدينة المهجورة التي تتدلى أشباحها من حبال الغسيل المنتشرة وسط الشارع، لكنها فكرت أيضاً بأن الرجل أذا كان ثرثاراً ولا يتوقف لحظة عن الكلام بقوة وحرارة، كهذا السائق، فلن يكون لدية الوقت الكاف للتفكير بإيذاء سيدة عجوز وحيدة جازفت بحياتها وتحملت أهوال المحيط من أجل رؤية الحبر الأعظم.
لاح لها البحر ثانية عندما وصلا الى نهاية هذه المتاهة من الشوارع. وواصلت سيارة الأجرة ترنحها على طول الساحل المهجور المشتعل المبقع بالعديد من الفنادق الصغيرة المطلية بألوان زاهية، لكنها لم تتوقف أمام أي منها، بل واصلت السير قدماً لتتوقف أمام فندق تلوح علية مسحة من الرصانة، ينتصب داخل حديقة عامة فيها أشجار نخيل عالية ومصاطب خضراء. وضع السائق صندوق الثياب على الطوار المظلل، و قال عندما شاهد التردد على وجه السنيورة برودنثيا لينورا، بأن هذا الفندق من أكثر فنادق نابولي احتشاما.
رفع حمال وسيم، طيب القلب صندوق الثياب على كتفيه وتولى مهمة العناية بها. وقادها الى مصعد ذو باب حديدي مشبك أضيف بشكل مرتجل الى بئر السلم، وأنطلق يغني بأعلى صوته وبإصرار مفزع لحناً لبوتشيني. لقد كانت البناية مهيبة، وتحتوي على فندق مختلف في كل طابق من طوابقها التسعة المرممة حديثاً. فجأة، وبنوع من الهلوسة، شعرت السنيورة برودنثيا لينيرو داخل المصعد بأنها محصورة داخل قن للدجاج يصعد ببطء وسط أصداء فراغ السلم المرمرية، ملتقطاً ومضات عابرة لنزلاء الطوابق الأخرى في شققهم وهم في أكثر لحظات غفلتهم حميمية، بسراويلهم الداخلية الممزقة وصوت تجشئاتهم الفائحة بالحموضة. عندما وصلا الطابق الثالث توقف المصعد مرتجاً، ثم توقف عامل الفندق عن الغناء، وفتح باب المصعد الحديدي المشبك القابل للطي وأشار بحركة توقير مسرحية موضحاً للسنيورة برودنثيا لينيرو أنهما وصلا الى شقتها.
في الردهة شاهدت مراهقاً يجلس بتكاسل خلف مكتب خشبي مطعم بزجاج ملون، ونباتات ظل في أصص من النحاس وأحبته على الفور لأنه كان يشبه حفيدها الأصغر بخصلات شعرة الملائكية المجعدة. وأحبت أسم الفندق، المحفورة حروفه على لوحة برونزية، وأحبت رائحة حمض الكاربوليك، وأحبت أغصان السرخس المتدلية، أحبت الصمت، أحبت زهور الزنبق التي كانت تزين ورق الجدران. ثم خطت خارج المصعد، وأنكمش قلبها عندما شاهدت مجموعة من السياح الإنكليز يرتدون بناطيل قصيرة وينتعلون صنادل خفيفة من النوع الذي يرتديه السياح على الشواطئ يغطون في النوم على صف طويل من الكراسي. كانوا سبعة عشر سائحاً، يجلسون بشكل متماثل، وكأنهم شخص واحد متكرر عدة مرات في ردهة للمرايا المتقابلة. مسحتهم السنيورة برودنثيا جميعاً بنظرة سريعة واحدة دون أن تفلح في تمييز أحدهما عن الآخر، وكل ما رأته كان طابور من الركب الوردية الشبيهة بشرائح لحم خنزير معلقة في محل جزارة. فأحجمت عن التقدم خطوة ثانية نحو طاولة استقبال الفندق، وتراجعت الى داخل المصعد، قائلة: دعنا نذهب الى طابق آخر.
قال عامل الفندق: “لكن هذا هو الفندق الوحيد الذي يحتوي على مطعم”
قالت “لا يهم”
أومأ العامل موافقاً، وأغلق المصعد، وشرع في غناء ما تبقى من الأغنية حتى توقفا عند الطابق الخامس. هنا بدا كل شيء أقل صرامة، والمالكة كانت سيدة ذات سحنة ربيعية تتحدث الإسبانية بطلاقة، ولم يكن ثمة أحد ينام القيلولة على الكراسي الموجودة في الردهة. لكن لم يكن هناك غرفة للطعام في الواقع، ولحل هذه المشكلة كان الفندق متفقاً مع أحد المطاعم لتزويد زبائنه بالطعام لقاء أجر زهيد. وهكذا قررت السنيورة برودنثيا لينيرو المبيت لليلة واحدة، بعد أن أقنعتها فصاحة سيدة الفندق ولطف شمائلها بالبقاء، بنفس القدر الذي أقنعها إحساسها بالارتياح لعدم وجود إنجليزي واحد أحمر الركبتين ينام في الردهة.
وفي الثالثة بعد الظهر أُغلقتْ الستائر في غرفة نومها، وامتصت العتمة الخفيفة داخل الغرفة الصمت البارد المنبعث من أيكة خفية، وأصبح المكان مهيأً للبكاء. وحالما وجدت السنيورة برودنثيا لينيرو نفسها وحدها سارعت الى غلق الباب بالرتاج، وتبولت للمرة الأولى منذ الصباح، مطلقةً خيطاً مائياً رفيعاً متردداً، جعلها تستعيد الإحساس بهويتها التي أضاعتها خلال الرحلة. ثم تمددت على جنبها الأيسر على السرير المزدوج الذي كان واسعاً جداً وموحشاً بالنسبة لامرأة وحيدة، وقامت بإطلاق سيل آخر من دموع طال احتباسها.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ريوهاشا وحسب، بل واحدة من المناسبات القليلة التي تركت فيها بيتها بعد زواج أبنائها ومغادرتهم للبيت، تاركينها للعيش وحيدة مع خادمتين هنديتين حافيتين للعناية بجسد زوجها الغاط في غيبوبة أبدية. لقد أمضت نصف عمرها داخل غرفة النوم قبالة ذلك الحطام البشري العائد للرجل الوحيد الذي منحته حبها، والذي ظل غائباً عن الوعي قرابة الثلاثين سنة، فوق حشية من جلد الماعز كانت تحتل السرير الذي شهد غرامياتهما الحميمة أيام الشباب. وخلال شهر أكتوبر المنصرم، فتح العليل عينيه في ومضة صحو مفاجئة، وتعرف على عائلته، وطلب منهم جلب مصور. وجلبوا مصوراً عجوزاً من الحديقة حاملاً كاميرته ذات الردن الأسود ولوحة مغنيسيوم لالتقاط الصور في البيت. وقام الرجل المريض بترتيب الصور بنفسه وقال، واحدة لبرودنثيا من أجل الحب والسعادة التي منحتهما إياي في حياتي، والتقطت هذه الصورة بأول ومضة للمغنيسيوم. ثم قال والآن صورتان أخريان لبنتي العزيزتين، برودنثيا وناتاليا. والتقطت الصورتين. والآن صورتين أخريين لولدي، اللذان أصبحا بحنانهما وسداد رأيهما مثالاً لجميع أفراد العائلة وهكذا دواليك حتى نفذ ورق التصوير وأضطر المصور الى أن يهرع الى بيته لجلب المزيد منه. وفي الساعة الرابعة عندما امتلأت الغرفة بدخان المغنيسيوم وبضجيج الحشد المؤلف من الأقارب والأصدقاء والمعارف الذين تدفقوا على المكان للحصول على نسخة من الصور أصبح الهواء داخل الغرفة غير صالح للتنفس، وبدأ الرجل العليل يفقد الوعي فوق سريره، وأخذ يلوح للجميع مودعاً وكأنه يقوم بمسح نفسه من صفحة الوجود وهو يقف على حاجز سفينة.
لم يجلب موته الراحة لقلب الأرملة كما كان يأمل الجميع. بل على العكس فقد سبب لها حزناً شديداً جعل أبنائها يجتمعون ليروا كيف يمكن لهم مواساتها، قالت لهم إنها ترغب بالسفر الى روما لمقابلة البابا.
“سأذهب لوحدي وسأرتدي مسوح القديس فرانسيس، لقد نذرت له نذرا ً”
لم يبق لها من كل تلك السنين الطوال التي قضتها في السهر والرعاية غير الراحة والعزاء اللذان يمنحهما البكاء. وعلى السفينة، عندما اضطرت الى مشاركة أختين من الطائفة الكلاريسية * نفس الغرفة قبل أن تغادرا السفينة في مرسيليا، كانت تقضي في الحمام وقتاً أطول من المعتاد ليتسنى لها البكاء دون رقيب. وبالنتيجة فقد كانت غرفة الفندق في نابولي المكان الوحيد المناسب الذي عثرت عليه منذ مغادرتها لريوهاشا حيث يمكنها البكاء ما شاء لها ذلك حتى تتسلل الراحة الى قلبها. وكان يمكن أن تواصل البكاء حتى اليوم التالي، لولا مجيء صاحبة الفندق وقرعها الباب في السابعة، موعد مغادرة القطار الى روما، لتخبرها بأنها لن تجد ما تأكله إن لم تنزل حالاً الى المطعم.
رافقها عامل الفندق. وفي هذه اللحظة كان نسيم منعش قد بدأ يهب من البحر، وعلى الشاطئ كان بعض السابحين لازالوا يتجولون تحت شمس الصباح الشاحبة. تبعت السنيورة برودنثيا لينيرو عامل الفندق الذي سار بها في شوارع منحدرة ضيقة ذات أرضية قاسية كانت تستيقظ للتو من قيلولة يوم الأحد، لتجد نفسها داخل تعريشة مظللة تستقر تحتها طاولات مغطاة بقماش مقصب بخطوط حمراء وجرار أُنبتت فيها زهور ورقية. كان المطعم خالياً من الزبائن في تلك الساعة المبكرة من النهار وكان الوحيدون الذين شاركوها الطعام هم الخدم والخادمات وقس معدم كان يتناول خبزاً وبصلاً على طاولة سوداء. عندما دخلت شعرت بعيون الجميع تستقر على ردائها البني، لكن ذلك لم يؤثر بها، لأنها كانت تعرف بأن السخرية كانت جزء من كفارتها. من جانب آخر أثارت الخادمة إحساسها بالشفقة، لأنها كانت شقراء وجميلة، وتتكلم كما لو كانت تغني. وفكرت السنيورة برودنثيا لينيرو بأن الأوضاع في إيطاليا بعد الحرب كانت لابد سيئة جداً وإلا لما اضطرت فتاة مثلها للخدمة في مطعم. لكنها شعرت بالراحة تحت التعريشة المزهرة، وأيقظت نكهة المرق المطهي بورق الكستناء المنبعثة من المطبخ إحساسها بالجوع الذي أجلته متاعب وقلق ذلك اليوم. وأحست للمرة الأولى منذ زمن طويل بأنها لم تكن راغبة بالبكاء. ومع ذلك لم تتمكن من الأكل كما كانت تشتهي، لأنها من ناحية لم تكن قادرة على التفاهم مع الخادمة الشقراء، رغم ما أبدته الأخيرة من حنان وصبر، ومن ناحية أخرى لأن اللحم الوحيد المتوفر في المطعم هو لحم الطيور الصغيرة المغردة التي يربونها داخل الأقفاص في ريوهاشا. حاول القس الذي كان يلتهم طعامه في الزاوية، والذي ترجم لها فيما بعد، أن يفهمها بأن حالة الطوارئ في اوربا لم تنته بعد، وبأن وجود عدد قليل من طيور الغابات صالح للأكل يعد على الأقل معجزة بحد ذاته. لكنها أبت أن تأكل ودفعت بالطعام بعيداً.
وقالت:
“بالنسبة لي سيكون الأمر مثل إلتهام واحداً من أبنائي.”
وانتهى بها الأمر الى تناول حساء من الشعرية، وصحن من القرع المطبوخ مع شرائح صغيرة من لحم الخنزير المقدد الزنخة، وقطعة خبز صلبة كالرخام. وبينما كانت تأكل، أقترب القس من طاولتها وطلب منها أن تشتري له قدح من الشاي على سبيل الإحسان. كان قساً يوغسلافياً عاش شطراً من حياته مبشراً في بوليفيا، وكان ينطق الإسبانية بطريقة خرقاء، معبرة. وبدا للسنيورة برودنثيا لينيرو مجرد شخص عادي لا يحمل محياه أي أثر للانغماس في الحياة الروحية، مستدلة على ذلك من يديه المخزيتين وأظافره المهشمة القذرة، ورائحة البصل العنيدة في أنفاسه والتي بدت على الأرجح كجزء لا يتجزأ من شخصيته. لكنه كان يعمل في خدمة الرب، على أي حال، وكان من دواعي سرورها كذلك، وهي على هذا البعد السحيق عن الوطن، أن تقابل إنساناً تستطيع التحدث إليه. تحدثا على مهل، غير منتبهين لضجة الفناء العالية التي أخذت تطوقهم عندما أخذ المزيد من الزبائن يشغل الطاولات الأخرى المجاورة. كانت السنيورة برودنثيا لينيرو قد توصلت الى اتخاذ قرار قاطع يتلخص في عدم حبها لإيطاليا. ولايعود السبب في ذلك الى كون رجالها غير محتشمين بعض الشيء، وهو أمر يعني الكثير، أو لأنهم كانوا يلتهمون الطيور المغردة، وهو أمر لا يمكنها قبوله، بل بسبب عادتهم الشريرة في ترك الغرقى يطفون على الماء.
أما القس الذي كان قد طلب على حسابها كأساً من شراب الغرابا وقهوة، فقد حاول أن يوضح لها سطحية رأيها بالإيطاليين، لأنهم أسسوا خلال الحرب نظاماً فعالاً جداً للإنقاذ والتعرف على ضحايا الغرق الذين يُعثر عليهم طافين في خليج نابولي ودفنهم في رحم الأرض المقدسة. وختم القس حديثه قائلاً قبل قرون اكتشف الإيطاليون بأن الحياة تُعاش مرة واحدة، لذا ترينهم يفعلون ما بوسعهم لكي يحققوا ذلك على أكمل وجه. لقد جعلهم هذا الاكتشاف حريصون وثرثارون، لكنه طهرهم أيضاً من أدران القسوة.
قالت إنهم لم يبادروا حتى الى إيقاف السفينة.
قال القس ما يفعلونه عادة هو الاتصال بسلطات الميناء عبر الراديو. سيكونون قد التقطوه الآن ودفنوه باسم الرب. .
بدّل النقاش مزاجيهما. وفي اللحظة التي أنهت فيها السنيورة برودنثيا لينيرو طعامها، انتبهت الى أن جميع الطاولات أصبحت مشغولة. وشاهدت على الطاولات القريبة، سواح شبه عراة يلتهمون الطعام بصمت، وبينهم بعض العشاق الذين كانوا يتبادلون القبل ولا يأكلون. وفي الطاولات الخلفية، القريبة من البار، كان أبناء الحي يلعبون النرد ويحتسون نبيذاً شفافاً. وفهمت السنيورة برودنثيا لينيرو بأنها كانت تملك سبباً واحداً فقط لوجودها في هذا البلد الكريه.
سألته هل تعتقد أن رؤية البابا ستكون صعبة جداً؟
ورد القس قائلاً بأن لا شيء أسهل من ذلك في الصيف. لقد كان البابا في الفاتيكان في قلعة غوندولفو، وفي أماسي الأربعاء كان يلقي بموعظة جماعية لجموع الحجاج الوافدين من شتى أنحاء العالم. وكان رسم الدخول زهيداً جداً: عشرون ليرة فقط.
سألته وكم يتقاضى لقاء الاستماع الى اعترافات شخص ما؟
قال القس مفزوعاً الأب المقدس لا يسمع الاعترافات، عدا اعترافات الملوك طبعاً.
قالت لا أدري لماذا يحرم عجوز مسكينة من تلك المنة التي تجشمت لأجلها كل هذا العناء
قال القس وبعض الملوك، رغم كونهم ملوكاً، يموتون من فرط الانتظار. لكن أخبريني هل إن خطيئتك كبيرة الى الحد الذي يدعوك الى هذا السفر الطويل لوحدك لمجرد الاعتراف أمام قداسة البابا.
فكرت السنيورة برودنثيا لينورا قليلاً، وشاهد القس ابتسامتها للمرة الأولى.
قالت يا أم الرب، سأرضى بمجرد النظر اليه. ثم أضافت بإشارة بدت نابعة من روحها إنه الحلم الذي انتظرته طوال حياتي.
وفي الحقيقة كانت لاتزال تشعر بالخوف والتعاسة، وكل ما كانت تطلبه هو أن تغادر المطعم وإيطاليا على السواء دون إبطاء. ويبدو أن الراهب فكر بأنه لن ينال من هذه العجوز المخدوعة أكثر مما نال، فقرر تركها متمنياً لها حظاً طيباً وذهب الى طاولة أخرى ليستجدي باسم الإحسان كوباً آخراً من القهوة.
عندما خرجت من المطعم، وجدت السنيورة برودنثيا لينيرو نفسها في مدينة أخرى مختلفة. أدهشتها أشعة شمس التاسعة، وأخافها الحشد الصاخب الذي أحتل الشوارع وحرمها من سلوى التمتع بنسيم المساء. لقد شعرت بأن الحياة مستحيلة وسط كل هذه الدراجات النارية من نوع فيسبا التي كانت تهدر بجنون، والتي يقودها رجال عراة الصدور مع نسائهم الجميلات الجالسات خلفهم، المتشبثات بخصورهم. كانوا يجعلون الدراجات تثب فجأة، وهم ينطلقون بها متمايلين وسط لحوم الخنازير المعلقة وبسطات البطيخ. كان جواً كرنفالياً، لكنه بالنسبة للسنيورة برودنثيا لينيرو كان كارثياً. فظلّت طريقها، ووجدت نفسها فجأة في شارع غير مناسب تجلس فيه نسوة صامتات على عتبات بيوت متشابهة وامضة بمصابيح حمراء جعلتها ترتجف ذعراٌ. تبعها مسافة عدة بنايات رجل أنيق يرتدي خاتماً ذهبياً ثقيلاً ويضع ماسة في ربطة عنقه وقال لها شيئاً بالإيطالية، ثم بالإنكليزية والفرنسية. وعندما لم يستلم منها رداً، أراها بطاقة بريدية من علبة استلها من جيبه، وبلمحة سريعة لتلك البطاقة شعرت إنها كانت تجوس في دروب الجحيم.
فرت فزعة، وفي نهاية الشارع عثرت ثانية على البحر الشفقي وشمت نفس رائحة المحار المتفسخ العطنة الشبيهة برائحة ميناء ريوهاشا فأحست بالسكينة تعود الى قلبها المضطرب. وميزت ثانية نفس الفنادق الملونة الموجودة على طول الشاطئ المهجور، و‘تكسيات‘المآتم، وماسة أول نجم يظهر في السماء الشاسعة. وفي الطرف القصي للخليج، ميزت سفينتها التي أبحرت على متنها، تجثم وحيدة وعملاقة عند رصيف المرفأ، متوهجة بالأنوار في جميع طوابقه، وشعرت بأنها لا ترتبط بها بأي صلة. انحرفت نحو اليسار عند المنعطف لكنها عجزت عن الاستمرار بسبب وجود حشد أوقفته شرطة الكاربينيري. وكان هناك صف من سيارات الإسعاف يقف منتظراً بأبواب مفتوحة خارج بناية فندقها.
وقفت السنيورة برودنثيا لينيرو على أطراف أصابعها لتنظر من خلف أكتاف المتجمهرين، وشاهدت السياح الإنكليز ثانية. كانوا يُحملون الى الخارج على نقالات، واحداً تلو الآخر، وجميعهم بلا حراك وفي وجوههم تلوح سيماء من الجلال ولايزالون يشبهون رجلاً واحداً مكرراً عدة مرات في ثيابهم الأكثر رسمية التي ارتدوها لتناول العشاء؛ وهي سراويل من الفلانيل، وربطات عنق مزينة بخطوط مائلة، وسترات داكنة اللون مطرزة على جيب الصدر بشعار النبالة العائد لترينيتي كوليج. عندما كانوا يخرجونهم، كان الجيران الذين يراقبون المشهد من الشرفات، والناس الذين مُنعوا من الاقتراب، يعدونهم في آن واحد كما لوكانوا موجودين في ملعب كرة قدم. لقد كانوا سبعة عشر. وضعوهم إثنين إثنين في سيارات الإسعاف التي انطلقت بهم على صوت صفاراتها الحربية.
دخلت السنيورة برودنثيا لينيرو المصعد، بعد أن صعقها ماشهدته من أحداث، وأنحشرت مع نزلاء الفنادق الأخرى الذين كانوا يهدرون بلغات عصية على الفهم. وبعد تفرقهم في جميع الطواق عدا الطابق الثالث، الذي كان مفتوحاً ومضاءاً، لكن لم يكن فيه أحد خلف طاولة الاستقبال أو على كراسي الردهة حيث شاهدت الركب الوردية للإنكليز السبعة عشر النائمين. علقت مالكة الطابق الخامس على الكارثة بعاطفة مشبوبة، قائلة للسنيورة برودنثيا لينيرو بالإسبانية لقد ماتوا جميعاً. لقد سممهم حساء المحار الذي تناولوه على العشاء. تخيلي، محار في أغسطس!
ناولتها مفتاح غرفتها، ولم تعرها مزيد من الاهتمام وراحت تقول للضيوف الآخرين بلهجتها الخاصة نظراً لعدم وجود غرفة للطعام هنا، فكل من يذهب للرقاد هنا يصحو حياً!
أقفلت السنيورة برودنثيا لينيرو الباب بالمزلاجين، وهي تشعر بغصة أخرى من الدموع الحبيسة تتجمع في حنجرتها. بعد ذلك دفعت بطاولة الكتابة الصغيرة وكرسي الجلوس وصندوق ثيابها تجاه الباب ليكونوا متراساً يصعب اختراقه من قبل فضائع هذا البلد الذي تحدث فيه الكثير من الأشياء دفعة واحدة. ثم ارتدت منامتها الخاصة بالأرامل، وتمددت على ظهرها في السرير، وتلت سبعة عشر صلاةً للإنكليز السبعة عشر المسمومين.
_____________
* طائفة كلاريس الفقيرة: طائفة من الراهبات تتفرع عن طائفة القديس فرانسيس الأسيسي و تنتسب الى سيدة من طبقة النبلاء تدعى كلاريس أو كلير الأسيسية تركت كل جاهها ومالها وعاشت حياة متقشفة كرستها للعبادة وطلب المغفرة متأثرة بالقديس فرانسيس الأسيسي.
المترجم عن الموسوعة البريطانية الميسرة.