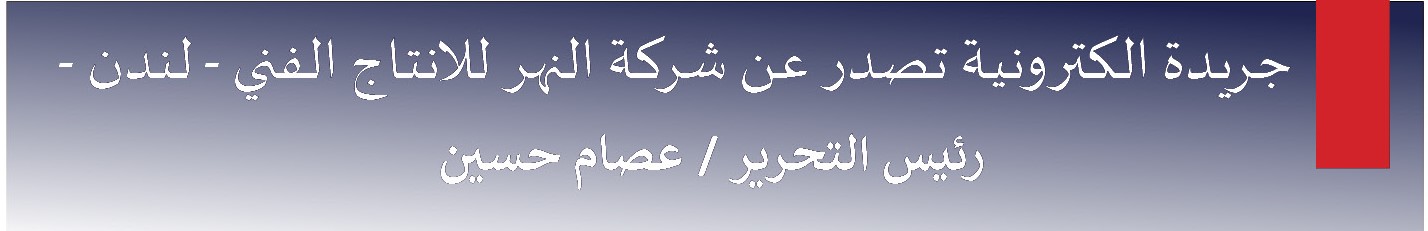“منزل الأشباح” قصة قصيرة للروائي أمبروس بيرس
ترجمة علي سالم


تدوين نيوز – خاص
على الطريق المؤدية الى الشمال من مدينة مانشستر في ولاية كنتاكي الشرقية، ولمسافة عشرون ميلًا من بونفيل، كان ينتصب في عام 1862 منزلاً ريفيًا من الخشب كان يبدو أفضل حالًا نوعا ما من معظم المنازل المجاورة له في تلك المنطقة. وبعد مرور عام من ذلك التاريخ تعرض هذا المنزل الى الدمار عندما شب فيه حريق مفاجئ، أشعلته، على الأرجح، بعض فلول قوات الجنرال مورغن دبليو المندحرة، التي أجبرها الجنرال كيربي سميث على الانسحاب من كمبرلاند كاب إلى نهر أوهايو. في ذلك الوقت الذي أُحرق فيه المنزل، كان قد مضى عليه مدة أربع أو خمس سنين تقريبًا كان فيها شاغرًا من السكان ومحاطًا بحقول مهجورة أمست هي أيضًا ضحية للدغل والأشواك. كانت أسيجة المنزل قد تهدمت، ولم تكتف أصابع النسيان والخراب بذلك، بل طالت جزئيًا حتى مساكن الزنوج، والمنازل الخارجية عموما، بسبب الإهمال والنهب، لأن الزنوج والفقراء البيض الساكنين في الجوار كانوا قد وجدوا في المبنى وأسيجته إمدادات وفيرة من الوقود، استفادوا منها دون أي تردد، وبشكل علني وفي وضح النهار. كانوا يرتادون المنزل خلال النهار فقط، ويتجنبونه في الليل إذ لم يكن بوسع أي إنسان الاقتراب من المنزل بعد حلول الظلام، اللهم إلا بعض الغرباء العابرين.
كان المنزل يُعرف باسم “منزل الأشباح”، أي أن أرواحًا شريرة كانت تسكنه، مرئية، مسموعة ونشطة، ولم يعد أحد في تلك المنطقة برمتها يشك أكثر من شكه فيما قيل له أيام الآحاد بواسطة الواعظ الجوال. أما رأي أصحاب المنزل في هذه المسألة فقد كان غير معروفًا، لأنهم اختفوا جميعًا في ليلة واحدة، ولم يُعثر لهم على أثر. لقد تركوا كل شيء خلفهم.. أغراض المنزل والثياب والمؤن والخيول في الإسطبل، والأبقار في الحقل، وعبيدهم الزنوج في أكواخهم.. وبقي كل شيء في المنزل على حاله دون تغيير، ودون أن تمسسه يد أنسان.. باستثناء شيء واحد فقط وهو اختفاء ساكنيه المؤلفين من رجل وامرأة، وثلاث فتيات، وصبي، وطفل صغير!
لم يكن من المستغرب أن يختفي تمامًا من مزرعة سبعة من البشر في وقت واحد ولا تساور ذهن رجل عاقل واحد بعض الشكوك. وفي ليلة من ليالي حزيران عام 1859، جاء الى هذا المنزل بالصدفة مواطنان من منطقة فرانكفورت كانا مسافران على فرسيهما من بونفيل الى مانشيستر وهما الكولونيل جاي سي مكاردل، وكان يعمل محامياً، ورفيقه القاضي ميرون فاي، الذي كان يعمل مع القوة الشعبية التابعة للولاية. كان هذان الرجلان بصدد القيام بمهمة ذات أهمية قصوى في ذلك المساء الذي قادتهم فيه الصدفة الى منزل الأشباح ولم يكن ممكناً لهما التخلي عن أداء مهمتهما، رغم سوء الأحوال الجوية ورداءة الطقس والظلام الدامس وهمهمات العاصفة التي كانت على وشك الانفجار. بعد حين داهمتهما العاصفة فعلًا وهما في منتصف الطريق، وكان ذلك عندما أصبحا على مقربة من منزل الأشباح. أخذ البرق يهدر بقوة مما أجبرهما على الاحتماء بذلك المنزل لأنهما لم يجدا أي صعوبة في الدخول اليه عبر بوابته المهجورة التي قادتهما الى سقيفة دخلا اليها هربًا من هزيم الرعد وهدير العاصفة التي انفلتت من عقالها للتو. ترجلا من على فرسيهما وربطاهما هناك داخل حماء السقيفة وهرعا إلى داخل المنزل، عبر المطر المنهمر، وأخذا يطرقان على جميع الأبواب، لكن طرقاتهما لم تجد لها آذانًا صاغية، إذ لم يأت أحد ليفتح الباب لهما، وفسرا ذلك بأن ساكني المنزل كانوا غير قادرين على سماع صوتيهما أو سماع قرعهما المتواصل على جميع الأبواب بسبب هدير الرعد المتواصل ودمدمة العاصفة الهادرة، فدفعا أحد الأبواب ودخلا. أنفتح الباب بسهولة، ووجدا نفسيهما في تلك اللحظة داخل نسيج كثيف من الظلام والصمت. كان الظلام كثيفًا صلدًا بحيث لم تستطع حتى أشد خيوط البرق لمعانًا واشتعالًا من تسريب شبه بصيص من النور عبر شقوق المنزل ونوافذه الى جوف المنزل الدامس أو حتى همسة واحدة من همسات المعمعة الهادرة في الخارج. لقد شعرا بأنهما قد تعرضا لصاعقة أتلفت منهما السمع والبصر. فيما بعد قال مكاردل بانه شعر للحظة وكأن هزيم الرعد قد أرداه قتيلًا حالما خطت قدماه عتبة ذلك المنزل المهجور. والآن لنترك هذا المحامي القادم من فرانكفورت يسرد لنا وقائع مغامرته التي دارت أحداثها في السادس من آب عام 1876: “عندما تمكنت بطريقة ما من السيطرة على شعوري العابر بالانتقال من دوي العاصفة الهادرة في الخارج الى الصمت المطبق داخل المنزل، تركز دافعي الأول في إعادة فتح الباب الخارجي الذي كنت قد دخلت منه الى المنزل وأغلقته خلفي، والذي لم أشعر بأني رفعت يدي عن أكرته بعد، إذ كنت أشعر بوضوح أنها كانت لاتزال في قبضتي. كنت أنوي فتح الباب ثانية للخروج الى العاصفة لكي أتأكد من أنها لم تستلب مني سمعي وبصري، لكني عندما فتحت الباب وجدت نفسي أدلف الى غرفة أخرى!”
” كانت الغرفة مضاءة بنور أخضر خافت، لا أدري من أي مكان كان ينبعث، لكنه كان يجعل كل شيء باديًا للعيان بوضوح، رغم أن ذلك الوضوح لم يكن كافيًا لتبيان جميع التفاصيل بدقة متناهية. يجب أن استدرك هنا بأن عبارة ” كل شيء” تبدو فضفاضة نوعًا ما، لأن محتويات الغرفة كانت تقتصر على جثث آدمية فقط ممتزجة بالجدران الحجرية الملساء لتلك الغرفة. كان عدد الجثث يتراوح ما بين الثمانية والعشرة.. لكن ينبغي للقارئ أن يفهم بأني لم أقف في مكاني وأقوم هكذا ببساطة بعدها. كانت أعمار أو قل أحجام أصحاب تلك الجثث مختلفة، من الطفل الى الشيخ الكبير، ومن كلا الجنسين. جميع الجثث كانت منكبة على وجوهها على الأرض، عدا واحدة، بدت أنها لفتاة في مقتبل العمر، كانت جالسة، وقد إتكيت على زاوية من زوايا الجدار. وكان ثمة طفل صغير يرقد في أحضان جثة امرأة بدت أكبر سناً من الأولى وهناك جثة لصبي في مقتبل العمر كان منبطحاً فوق ساقي رجل ملتح. اثنان أو ثلاثة أخرون كانوا شبه عراة، وفتاة أخرى كانت تمسك بيدها خرقة من القماش منتزعة من ثوبها الذي مزقته من الجانب الذي يغطي ثدييها. كانت الأجساد الميتة قد بلغت مراحل مختلفة من التحلل، وكانت وجوهها وأجسادها جميعاً قد تبعجت وفقدت معالمها. البعض منها لم يبق منها غير هياكلها العظمية.”
“بينما كنت واقفاً أنظر الى ذلك المشهد المخيف بعيون جمدها الرعب ويدي لاتزال على أكرة الباب المفتوح، زاغ بصري واهتمامي بطريقة لا يسعني وصفها من هذه الصورة المروعة وأخذ يحوم حول تفاصيل وتفاهات لا قيمة لها، ولعلها كانت حيلة ما افتعلها عقلي بشكل غريزي لكي ينجيني من خطر صدمة قاتلة. من بين تلك التفاصيل التي شدت انتباهي كانت صفائح الباب الذي كنت لا أزال ممسكًا به مفتوحًا. لقد لاحظت بأن ذلك الباب كان مصنوعًا من صفائح حديدية ثقيلة، مثبتة في أماكنها بالمسامير وعلى أبعاد متساوية من بعضها البعض ومن الأعلى الى الأسفل برزت ثلاثة مزاليج قوية عند حافة الباب المائلة. أدرت أكرة الباب فتراجعت متساوية مع الحافة؛ وعندما تركت الأكرة تعود الى مكانها الطبيعي، عادت المزاليج الى مكانها. كان الباب مزودًا بنوع من الأقفال النابضية، لكن في الداخل لم يكن للباب مقبض، ولا أشي آخر بارز يمكن أن يُستخدم لهذا الغرض.. لأن الباب كان عبارة عن سطح أملس من الحديد.”
“وبينما كنت منشغلاً بملاحظة هذه الأشياء باهتمام متزايد لازلت أتذكره الآن بدهشة كبيرة، شعرت بيد تدفعني جانبًا لتسمح لصاحبها بدخول الغرفة، ولم تكن تلك اليد سوى يد القاضي فاي، الذي كنت قد نسيت وجوده تمامًا نتيجة لارتباك مشاعري والاضطراب النفسي الذي كنت أعاني منه في تلك اللحظة. “بحق الإله؛” صحت خائفًا” لا تدخل الى الغرفة ودعنا نغادر هذا المكان المرعب!”
لكنه لم يعر بالًا لندائي وتوسلاتي (وكان في ذلك لا يقل شجاعة عن أي جنوبي حقيقي) وسار بسرعة الى منتصف الغرفة، وجثا بالقرب من إحدى الجثث ليتفحصها عن كثب، رافعًا رأسها الأسود المنكمش برقة بين يديه. عندما فعل ذلك هبت عبر الباب رائحة عفن قوية وغلفت حواسي بالكامل. شعرت بالدوار والغثيان؛ وأحسست بأني غير قادر على الوقوف على قدمي، فمددت يدي الى مقبض الباب لكي أستند عليه وأمنع نفسي من السقوط على الأرض، لكني بعملي هذا جعلت الباب ينغلق بقوة مصدرًا رنينًا معدنيًا!”
“لا أتذكر المزيد مما حدث: لكني ثبتُ الى رشدي بعد ستة أسابيع في أحد فنادق مانشستر، حيث نقلني الى هناك في اليوم التالي بعض الغرباء، وكنت أعاني طوال تلك المدة من الحمى العصبية والهذيان المتواصل. لقد عثروا على مرميًا على قارعة الطريق على مسافة بضعة أميال بعيدًا عن المنزل؛ لكن كيف تسنى لي الهروب منه والوصول الى ذلك المكان، لا أدري. عندما تماثلت للشفاء، أو قل عندما سمح لي طبيبي المعالج بالكلام، كان أول سؤال لي بالطبع هو الاستفسار عن مصير القاضي فاي، والذي (كما قالوا لي ليهدؤوا من روعي) بأنه كان بخير وفي منزله.”
“لم يصدق أحد حرفًا واحدًا مما قلت، ومن كان سيصدق؟ ومن كان يتخيل حجم أحزاني عندما عدت الى بيتي في فرانكفورت بعد شهرين ليقولوا لي بأن القاضي فاي قد انقطعت أخباره منذ تلك الليلة؟ لقد جعلتني هذه الأخبار أندم بمرارة على كبريائي الذي منعني بعد يومين من تماثلي للشفاء من إعادة سرد قصتي العجيبة التي لم يصدقها أحد، كان ينبغي لي أن أصر على أن ما حدث كان حقيقة لا تقبل الشك.
والآن ليس ثمة من جديد أستطيع إضافته الى معلومات قراء صحيفة “الأدفوكات” بخصوص ما حدث لاحقًا.. فالجميع على علم بمسالة تفتيش المنزل وفشل المفتشين في العثور على غرفة تتطابق مواصفاتها مع مواصفات الغرفة التي ذكرتها؛ هم على علم أيضًا بمحاولة إلصاق تهمة الجنون بي ودحضي لأولئك الذين حاولوا إلصاق هذه التهمة بي. لكن بعد مرور كل هذه السنين لازلت مقتنعًا بأن الحفريات التي لا أملك الحق القانوني في إجرائها ولا المال الكافي لتغطية نفقاتها ستكون كفيلة بكشف سر اختفاء صديقي التعس، وربما ألقت الضوء على ملابسات اختفاء سكان المنزل الأصليين الذي هجروا منزلهم الذي أصبح الآن أرض خربة. لم أيأس تمامًا من إمكانية تحقيق ذلك، لكن يحزنني أن يكون مشروع الحفر والتنقيب هذا عرضة للتعطيل والإهمال من عائلة صديقي القاضي فاي نفسه والتي عاملتني بكل مظاهر العدوانية وعدم التصديق.”
توفي الكولونيل مكاردل في فرانكفورت في الثالث عشر من كانون الأول عام 1879.