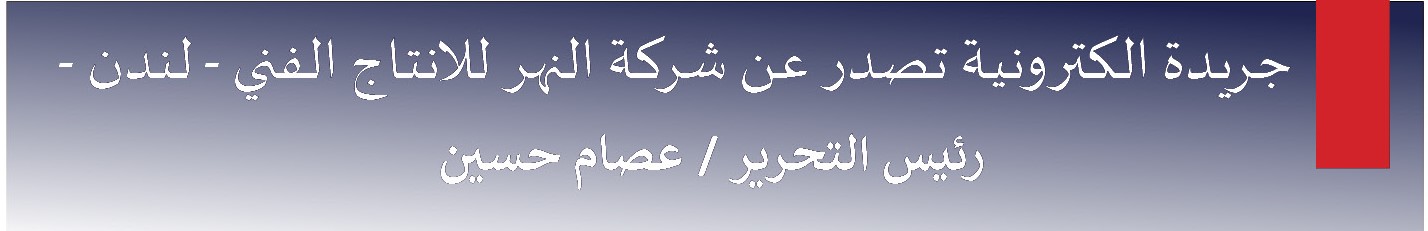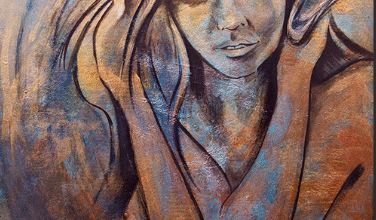“مُعاناةٌ .. فالوقتُ” خَطْب” للقاص زيد الشهيد

تدوين نيوز – خاص

في ما مضى من الأعوام كانت مدينتنا التي تتربَّصُ بها الصَّحراء لتبتلعها ويحرصُ الفراتُ على عدمِ التفريط بها فيمدّها بالإغراء المائي كي تبقى جارةً له، تَتحسَّب لطوارئ الشتاء وتهيئ مُستلزمات السيطرةِ على المواقف والتجاوز عليها، لكنَّها هذه المرَّة أعلنت أنَّ هاته المستلزمات ما هي إلا محاولات بائسة ويائسة تبعث على السخرية المُرَّة، فالقادمُ القريب من الساعات يُنذر بالثبورِ وينادي بالويل ، وما هذه الريح التي نراها الآن تصفع وجوهَ الأبنية فتدميها بالماء وتضرب هامات الاشجار فتذلُّ كبرياءَها وتولول بهواءٍ أخرقَ يُشعرنا كأنَّنا ريشٌ يوشِك أنْ يطيرَ إلا ترجمةً لمعركةِ ريحٍ مائيةٍ تُدرِك انتصارَها مُسبَقاً .
ذلك الصباح المدلَهِم رأيت جدَّي الذي كانَ بمعطفِه الصوفي الاسودِ السميك ينتصب في وسطِ الصَّالةِ مكتئباً يطالع زجاجَ النافذة وهي تتلقّى رشقات المَطر المتلاطم مدويّةً ، صاعِقةً . بجانبه منضدةٌ تتراكمُ عليها أوراقُ تدويناته عن حادثةٍ أرادَ جعلَها مِثالاً لرؤيةٍ هي محورُ مَقالةٍ سينتهي منها: ” المطرُ بكاءُ السَّماء على أرضٍ يدوسها الانسانُ الجاحِد بعقبيه.”
كانت شجرةُ السِّدِر الهائلةِ التي تنتصبُ على رصيفِ الشارع المُقابل لبيتِنا ويطالعُها جَدّي آنذاك بكآبةٍ قد وهَنت، بعدما كافَحت وبكلِّ اصرارِ الشَّجر الذي لا يموت الا وهو واقفٌ، بفعلِ الريحِ الهادرِ ، العاصِف ، القادمِ مِن كلِّ الاتّجاهات والذي استمرَّ يصفعُها طوالَ ساعاتِ الليلِ وبدَت كليلةً كأنّها شجرةٍ تعيشُ الشيخوخةَ وتستسلمُ للذواء .. ينهالُ عليها الماءُ الهاطلُ مِدراراً بعد أنْ هبَّت عليها رياحُ الشّمال الآتية من جهةِ النهرِ ( إنَّ ريحَ الشمالِ شتاءً هويةٌ تُنبىء بالمطر). أوراقُها الخضراءُ الصغيرةُ التي اعتادت أنْ تكونَ مَشوبةً بغبارٍ تُحدِثه حركةُ السيارات المارّة في أيامِ الصحو استحالت لامعةً وأكثرَ دكنةٍ ، لاسيما والمطرُ يمرُّ عليها بهيئةِ خيوطٍ مائيةٍ تترك صوتاً أشبه بالكركرةِ ، أي كما لو أنَّها تضحكُ لأنّها لم تستحم مِن زَمان ، وكما لو أنَّ الفتيات الثلاث اللائي شاهدناهنَّ يهرعنَ إليها للاحتماءِ بها رُغمَ أنَّهن يرفَعن المظلات أعلى رؤوسهنَّ اتقاءً واكتشفنها على وشكِ الانهيارِ وتحطمها كدفاعاتٍ ساترةٍ لقاماتهنَّ ، لأنَّ المطرَ لم يكُن مَطراً إنَّما نَهراً يجري فوقَ المظلات .. وكانت السماءُ تطلق رصاصَها المائي على هيكلِها فيسلك مَجرى الأغصان فتستحيلُ أنهاراً تجري فوقَ رؤوسِهنَّ ، وأضحى عبورهنَّ للرصيفِ الآخر والاحتماء بالبنايات العالية من عِداد المُغامرةِ غير المحمودةِ بفعلِ الشارعِ الذي صارَ نَهراً يجمع مياه البحار والمحيطات ذكَّرَهُن بالنيل الذي قرأنَ عَنه في مناهجِهنَّ الدراسية أنّه حينَ كانَ يهدر هَوجاً ويفيضُ تخبّطاً لا يتوقّف إلا بأجملِ فتاةٍ تُساق مُجبرةً فتوهب له ( كلُّ واحدةٍ صوَّرَت المَشهد في ميدانِ قلقِها فتخيَّلت أنَّها الفتاةُ المحتملةُ الاختيار التي ستغرقُ في الهديرِ الحاصل بين الرصيفين فجفَلنَ جميعاً). أمّا نَحنُ الذي كنَّا نخوض في المياهِ المتدفّقةِ كنهرٍ فذكَّرنا هذا المطرُ الغادرُ بتلكَ السيارات المشبكة وأولئكَ الرجال الذين كانوا في قفصِها يلوِّحون لنا بمناديلَ وخرقٍ موحلة ؛ يكلِّموننا بنظراتٍ تُعلِمُنا بانَّهم يُعانونَ من خَطبٍ ، ولا يعرفون أينَ يُساقون … كنَّا نَعرف مثلَ هاته السيارات إلى أينَ تتَّجه . فقد خَبَرنا أقراناً لهم كثيرين كانوا يُجلَبون في الأيام الغائمة الملبَّدة برَصاصِ السُّحُب أو في صهدِ الصيف بمثلِ هذه الوسائط التي تتمثَّل رمزاً للقهر ، تمرُّ بمدينتنا ، ثم تخرج لتخترقُ الصحراءَ إلى أُخدودٍ بمثابةِ وادي تيه يُسميه آباؤنا ” نقرة السلمان ” ، سالبةً من عيونِهم مشاهدَ المدنِ ومعالمَها الوردية ، وصورَ حبيباتٍ لم يُسعفِهن الحظ بالتلويح بأكفِّ التوديع ، والوعد بالانتظارِ حتى لو كانَ الفراقُ دهراً . كان منظرُهم يغمر نفوسَنا بسيلِ المَرارة ودفقِ التأسي ؛ وكنّا نلوِّح لَهم بأكفِّنا الصغيرة ونحنُ نتلفت وَجلينَ خشيةَ عيونِ رجالِ الأمن الذين كانوا ينتشرونَ وقتَ مرورِها في الشارعِ الذي تسلكُه ونتحسَّب لشرورٍ يسكبونها على مسامِعنا شتائمَ وتحذيرات بالويل.
نستديرُ إلى الفتياتِ اللاتي احتمينَ بشجرةِ السدرِ وغدرت بهنَّ الأمواه المتسربة من بينِ الأوراقِ والأغصان فنلمحُ عربةَ باصٍ توقفت حذاءهنَّ، فاندفعنَ الى جوفِها في حالة انتصارٍ لا يضاهيه غيرُ الانتصارِ في معركةٍ غيرِ متكافئة.
وإذ أودِّعُ الصَّحبَ وأعود إلى بيتِنا أجدُ جدّي قد دوَّن: ” يا لها مِن شَجرةٍ عَصماء كم تحمَّلت مِن جنونِ الشتاء ! وكم صَمدت وتعالَت على جراحِها والكسور بفعلِ ريحِه ، وتخبطهِ، وعَصفه !”